يمثل عبد العزيز بركة ساكن حالة خاصة جدًا في الأدب المكتوب باللغة العربية، سواءً لجهة تنوع عوالمه الإبداعية وثرائها وصعوبة حصرها في تصنيف بعينه، أو لجهة عنايته بالشكل الروائي واشتغاله على بنية أعماله بحيث تكون نابعة من مضمونها وذات صلة بالواقع الذى تتناوله. عبر «الجنقو.. مسامير الأرض» و«سماهانى» و«الرجل الخراب» و«مسيح دارفور» وغيرها، نجح ساكن في تحقيق معادلة صعبة تمثلت في الوصول إلى مقروئية واسعة دون تنازل عن رؤاه الفنية أو عن ولعه بالتجريب البنائي واللغوي.
ومثلما نجحت هذه الأعمال بين قراء العربية، نجحت أيضًا ترجماتها إلى لغات عديدة، كما نالت جوائز كثيرة من بينها جائزة الطيب صالح للرواية، وجائزة الأدب العربى التى يمنحها معهد العالم العربي بباريس، إضافة إلى أكثر من جائزة فرنسية.
وفي فبراير الماضي، التقيت صاحب «مسيح دارفور» خلال مشاركتنا معًا في الدورة الأولى لمهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش، وعلى هامش المهرجان دارت بيننا نقاشات متنوعة نتج عنها في النهاية هذا الحوار، وهو ليس حوارًا بالمعنى المألوف، بل أقرب إلى دردشة عفوية، تحدثتُ فيها مع بركة ساكن عن المنفى والهوية وعلاقته باللغة وقضايا أخرى.
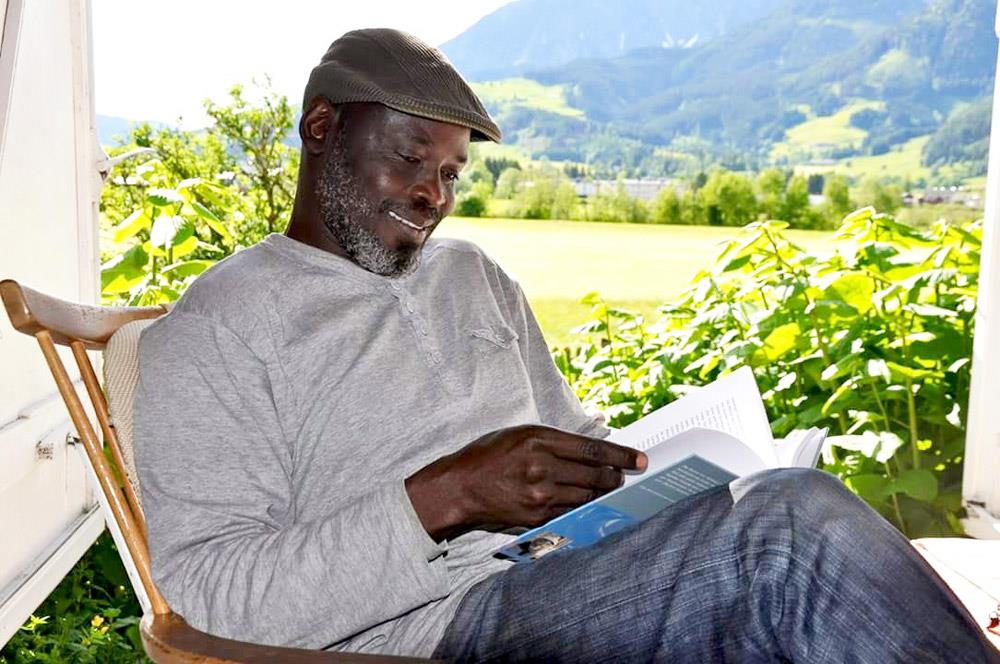
أحب أن أبدأ حوارى معك بالمنفى، ما الذي قدمه لك المنفى ككاتب وما الذي أخذه منك؟
أشكرك كثيرًا أولًا على الحوار، وأشكر جريدة أخبار الأدب، وأتذكر الحوار الذى كان أجُرى معي من قبل ونُشِر في أخبار الأدب. في الحقيقة هذا سؤال صعب، لأنني غير قادر على قول ماذا قدم لي المنفى بالضبط، لكنني أعرف تمامًا ما أخذه منى.
لنبدأ إذن بما أخذه منك؟
(يضحك) أولًا شوش المنفى ذاكرتي تمامًا. أصبحتُ بذاكرة مشوشة. عشتُ كل حياتي في السودان؛ في قرى ريفية، ومع المواطنين البسطاء، واشتغلت كل الأعمال التي تتخيلينها أو لا تتخيلينها في السودان. وهى ربطتني بالمكان وبالزمان وبالبشر، ربطًا ليس سهلًا.
هذه الذاكرة ليست ذاكرة مُعطاة أو يمكن إيجادها بسهولة، وهى أيضًا ليست ذاكرة مغلقة ولا تكتفى بما حدث، إنما تحتاج لتطوير وتراكمات يومية، لأن أي يوم يختلف عن اليوم الذى سبقه. وكل شخص تقابله هو شخص آخر.
أي مكان تمشى فيه هو مكان آخر. هذه الذاكرة تشوشت أو عطبت. المنفى عطب ذاكرتي تمامًا، ولم أستطع تكوين ذاكرة جديدة. هذه هي المشكلة. هذه الحضارة الموجودة في أوروبا لا تنتمى لي. والمكان لا ينتمى لي. اللغة لا تنتمى لي.

برغم إجادتك للّغتين؛ الألمانية والإنجليزية؟
اللغة التى أقصدها هنا ليست اللغة العادية التى تتكون من الكلمات، بل لغة المكان نفسه. عندما أمشى فى الشارع بالسودان، أتذكر تمامًا كيف كان هذا الشارع قبل أربعين سنة. أعرف الأشجار التى على جانبيه، وكيف فتحنا هذا الطريق! وكيف أعدنا تخطيط المدينة؟
كأن المدينة تحكى حكاياتها.
بالضبط، المدينة تحكى حكاياتها. هذه اللغة. أنا أفتقد لغة المكان وأفتقد لغة البشر. هنا أرى بشرًا، صحيح هم طيبون وكرماء ويوجد بينهم أشرار أيضًا، لكن لا أعرف ما وراء هذا الشخص. ما وراء اسمه؟ ما وراء وجوده الآن معي؟ ما التاريخ الذى يحمله؟ ما التحولات الثقافية العميقة المعقدة والتى كونته حتى أتفاهم معه؟ فلكى تعرف شخصًا ما، لا يتوقف هذا على الشكل الخارجى فقط أو التحاور معه بلغته، لا. أقصد المعرفة الدقيقة. قارنى هذا بعندما أكون فى مدينتى: أرى شخصًا ما، أعرف من هو أبوه وأمه، وجدته. أعرف حتى الأطفال ومن هى الداية التى ولَّدت أمهاتهم. حقيقة. أعرف تفاصيل التفاصيل عن مدينتى وأهلها، وهم يحبوننى وأنا أحبهم وأعرفهم.
أعرف النهر، وكيف كان مستوى الماء فيه. كيف انخفض مستوى الماء عندما بنوا الخزان، ثم حين بنوا خزانًا آخر. أعرف أنواع الأسماك، وأين نصطاد سمك البلطى وأين نصطاد سمك الطوبار وأين نصطاد الأسماك الأخرى، وأين نجد التماسيح. أعرف. حاليًا فى المنفى، النهر بالنسبة لى نهر فقط. أنهار فقط.
تحول إلى شىء مجرد.
نعم، من غير أسرار. عندما أتحدث عن اللغة، أتحدث عن لغة المكان، لغة الأشياء. فبالتالى أعرف الإنجليزية فى حال ذهبت إلى بريطانيا، لكننى لا أعرف بريطانيا رغم معرفتى باللغة الإنجليزية. فى ألمانيا، النمسا، أعرف اللغة الألمانية، لكننى لا أعرف حقيقةً اللغة الألمانية.
وأجيد التحدث بها، والقراءة بها، وممكن أن أكتب بها، لكن هذا لا يعنى أننى أعرف ما وراء هذا الشيء: التكوين الاجتماعى والثقافى والسياسى، كل هذه الأشياء. فالمنفى شوَّش ذاكرتى تمامًا، وحاليا أشعر بهذا الشيء. فى المقابل قدم لى الحرية. حرية الكتابة والأمان. وأنا أكتب، لا أحد يهتم بالموضوعات التى أكتب عنها، يهتمون فقط بفن الكتابة، تقنية الكتابة.

ويجد الكاتب نفسه فى سوق نشر ضخم جدًا، وفى هذا السوق الأدبى يجب أن تكون كتابته فى مستوى ما يُكتَب، وأن يكون هو ككاتب فى مستوى هؤلاء الكتاب. أن يثقف نفسه. ويقرأ جيدًا. يقابل الكتاب، يعيش الحياة الثقافية اليومية المتوافرة أمامه. كل هذا أفادنى كثيرًا. التقيت بكبار الكتاب والناشرين والمترجمين والمثقفين، الخ. هذا أيضا يطور الكثير من الأفكار.
كثيرون يعتبرون أن المنفى أساسًا تجربة لغوية، باعتباره نفيًا عن اللغة الأم، والوجود فى سياق لغوى غريب. وكلامك يؤكد هذا.
نعم، نفى عن اللغة، نفى عن مشاعرك الطبيعية. المنفى مثل الاستعمار.
بأى معنى؟
فى الاستعمار، تأتى دولة وتستعمر دولة أخرى وتفرض عليها لغة. المنفى، استعمار فردي. هناك، يستعمرون الشعب، هنا، أنت تُستعمَر بأشياء كثيرة جدًا. لا تُفرَض عليك أشياء، لكن أنت تحس بهذا الشيء.
تحس بهذه الخصومة مع اللغة، مع الأمكنة، الخصومة مع الأفكار الجديدة. هذا على الرغم من أننى فيما يخص موضوع الهوية، أعتبر أن الشخص ليست له هوية ثابتة، بل هو دائمًا يكتسب هويات جديدة كل يوم.
هذا رأيى أيضًا: الهوية الشخصية عمل قيد الإنجاز.
بالضبط، قيد الإنجاز. عملية مستمرة، ديناميكية. كل يوم يكتسب المرء هوية جديدة. قرأت كتابًا هذه هوية جديدة. قابلتك الآن، رغم أن هويتى فيها جزء مصرى، هويتك كشخصية أصبحت جزءًا من هويتى، هذا الحوار جزء من هويتى. وهذا المكان، الآن نحن فى المغرب؛ نشترى العطور المغربية، ونأكل طعامًا مغربيًا، ونحكى مع المغاربة، نعيش معهم. هذا أيضا إضافة لهويتينا.
الهوية شيء منفتح دائمًا، وقيد الإنجاز كما ذكرتِ أنتِ، دائمًا قيد التكوين. لكن على الرغم من هذا، يحس الإنسان بالغربة، أو الشوق إلى الوطن، والوطن عندى، ليس فكرة ضخمة. الوطن، هو قريتى الصغيرة، وبيتى الذى بنيته من الطين هو وطني. هذا هو الوطن الذى أشتاق إليه كأنه رحم. فالمنفى هو نفى عن اللغة، نفى عن المكان، نفى عن الزمان، نفى عن المشاعر وهو أيضًا نهب، نهب للذاكرة.
توجد رؤيتان متناقضتان تمامًا عربيًا عن العيش فى سياق مختلف عن السياق الأصلي: إما التشبث المبالغ فيه بالجذور واستدعاؤها طوال الوقت والكتابة عنها بشكل موسوم بالحنين والنوستالجيا بما يهدد بتزييف الرؤية، أو الاستلاب للمكان الجديد وإحساس البعض بأن مجرد وجودهم فى الغرب إنجاز فى حد ذاته. كيف تحمى نفسك من الوقوع فى أحد هذين الفخين؟
بالنسبة لى، هذا المنفى هو مكان آخر. فقط مكان آخر. مكان آخر بظروفه الموضوعية، مكان آخر بثقافته، مكان آخر بكل شيء. هو مكان آخر، وحتى كتابتى وأنا فيه لم تتغير كثيرًا من ناحية التقنية.
هى تطورت، لكن من ناحية الموضوعات، فلأنه مكان آخر، أكتب عن هذا المكان الآخر. فى «الغراب الذى أحبنى» وهى خماسية؛ خمس روايات تحكى عن المنفى، سوف تُنشَر فى مصر هذا العام.
المنفى مكان آخر، مكان مؤلم، وأشبه بالسجن المفتوح، وأنا فى السودان أيضًا كنت أعيش فى سجن مفتوح، وحتى فى سجون مغلقة. فى السودان سُجِنت أكثر من مرة، وحتى مصر التى أحبها دخلت السجن فيها من قبل.
ذكرت قبل قليل أنهم فى الغرب ينظرون ليس إلى موضوعات أعمالك، ولكن إلى تقنيات الكتابة. وأظن أن هذه حالة خاصة، لأن الشائع عن دور النشر الغربية عموما، فيما يخص الكتاب من العالم الثالث، أنها لا تركز على التقنيات، بقدر ما تهتم بالموضوعات وتُتهم حتى بأنها تتعامل مع هذه الروايات باعتبارها وثائق اجتماعية وسياسية وليست فنًا. وهناك من الكتاب من يُتهمون بمغازلة هذه الرؤية فى كتاباتهم. تجربة تلقى أعمالك فى الغرب مختلفة وفقًا لما تحكيه. من وجهة نظرك ما الذى ساعد فى هذا؟ هل للأمر علاقة بأن دار النشر مناسبة مثلًا ومتحمسة؟ أم ماذا؟
خلال دردشة سابقة بيننا اليوم، وفى سياق الحديث عن العلاقة بين الشكل والمضمون، أنتِ قلتِ إن المضمون ينادى على الشكل الملائم له، فهناك شكل معين لموضوع معين وموضوع معين لشكل معين.
أنا أتفق مع هذا الرأى، وفهمى أصلًا أن الرواية ليست الحكاية فقط، بل هى فن كتابة هذه الحكاية. والشىء الآخر الذى ذكرتيه فى سؤالك هو موضوع الناشر. ناشرتى لا تنشر ما لم تتحمس للعمل.
هى تحب الكتابة المعقدة، الكتابة ذات التقنيات الفنية الجديدة، وهذا شرط من شروطها. ولا تنشر إلا عشر روايات فقط كل سنة، وتختار هذه الروايات بدقة. الشىء الآخر المهم هو: هل الكتاب الأوروبيون الموجودون حاليًا يكتبون بتقنيات متقدمة؟ لا، يكتبون كتابة للسوق، تباع بسرعة ويقرأها القارئ المطمئن فى البيت وهو نائم، ومعظم النقاد الأوروبيين الذين كتبوا عن أعمالى قالوا هذه كتابة معقدة جدًا. لا يوجد حتى ناقد واحد لم يقل: هذا العمل معقد، مبنى بطريقة مختلفة ويحتاج إلى قارئ صبور.
حتى سألونى فى مؤتمر أدبى فى باريس: لماذا تكتب بهذه الطريقة؟ قلت هذه الطريقة ضد القارئ المطمئن، لأننى أصلًا غير مطمئن. أنا لا أطمئن لشىء، لماذا يطمئن هو؟ فبالتالى أنا أحول هذه الفكرة إلى تقنية فى الكتابة. وأنا تعلمت تقنية الكتابة المعقدة نفسها، من المجتمع.
كيف؟
قبل كتابة رواية «الجنقو مسامير الأرض» مثلًا، ذهبت إلى العمال الموسميين الذين كتبت عنهم وعشت معهم. لا يعرفون أننى كاتب ولا أى شيء. كنت أسافر معهم، أنام فى العراء، وألبس مثلهم كأنى واحد منهم. يشربون المريسة أشرب معهم. يغنون، أغنى معهم. يرقصون، أرقص معهم.
ولم أكن أبحث عن القصص، بل عن طريقة حكى القصص. أى كيف يحكون القصص؟ ما طريقتهم فى المؤانسة أو الونس؟ كنت أبحث عن تقنيات الحكى عندهم. وهم كانوا يحكون لى وكنت أحب أن أحكى لهم، وأحيانا أؤلف قصصًا من رأسى ويعجبون بها. هم يحكون فى المساء.
ويعودون من الشغل، فى بيت يُسمى بيت الأم والأم تفرش لهم جوالات ويرقدون فى الحوش، وبعد ذاك يحتسون العرق أو المريسة ويحكون. جميعهم يحكى فى نفس الوقت. يعنى لنقل مثلًا أن عشرين أو ثلاثين أو أربعين من العمال يحكون كلهم، ويردون على بعضهم البعض فى نفس الوقت.
والأغرب من هذا أن الذين فى هذا البيت يتآنسون مع الجيران الذين يفترشون الأرض فى البيت الآخر. تخيلى؟ أى أنها ونسة عبر الصريفة (نحن نسمى السياج الصريفة). هذا شىء كان مدهشًا جدًا بالنسبة لى، فبالتالى، بنيت قصة «الجنقو» على الحكايات المتداخلة والمترابطة فى نفس الوقت، المنفصلة والمتصلة أيضا ببعضها البعض وعابرة للأشخاص والمكان،
وهذا عملت عليه عشر سنوات. كتبت هذه الرواية عشر مرات. كل مرة أطور فى التقنية. كل القصص الموجود فى هذه الرواية، كلها خيالية، لكن فن الكتابة وتقنيتها ومواقع الراوى مستلهمة من الواقع.
وفى «مسيح دارفور» أيضًا استلهمت تقنيات من الواقع، لأننى حضرت الحرب وكنت مستشارًا فى الأمم المتحدة ودرَّست للجنود، وبالتالى عايشت الحرب. ولأن فى «مسيح دارفور» يوجد مسيح إذن لابد من استخدام تقنيات حكى أخرى. وما دام يوجد نبى فى هذه الرواية استخدمت طريقة حكى مُستلهَمة من الموروث الدينى. سورة الكهف مثلًا بها تقنيات سردية غريبة جدا وتداخل الأصوات فيها عالٍ، فاستخدمت هذه التقنية لتعدد الأصوات. ورغم أن تعدد الأصوات يُعتبر شيئًا جديدًا فى أوروبا، إلا أنه موجود فى تراثنا. أى أننى انتبهت إلى تقنيات سردية موروثة، واستفدت منها.
تحدثت فى الندوة التى شاركت فيها بمهرجان الكتاب الإفريقى بمراكش عن التعدد اللغوى فى السودان، وأشرت إلى وجود 74 لغة فيه؛ لوالدك لغة ولوالدتك لغة مغايرة. وواضح من كلامك أن هذا عقَّد علاقتك باللغة العربية.
«يقاطعني» لم يعقد علاقتى باللغة العربية، بل عقد علاقتى باللغات بشكل عام.
بفكرة اللغة عمومًا؟
نعم
إذن أنت تكتب بلغة، وخيالك ونشأتك وتفاصيلك الحميمة بلغتين أخريين هما لغة الأم ولغة الأب، كيف انعكس هذا على كتابتك؟
هذا مهم، ويظهر فى أعمالى بشكل واضح. توجد فى كتبى لغات كثيرة جدًا، وقد نال المترجم والأكاديمى البلجيكى كزافييه لوفان، أكبر جائزة مخصصة للترجمة فى فرنسا عن ترجمته «الجنقو مسامير الأرض» إلى اللغة الفرنسية.
لوجود اشتغال لغوى واضح فى العمل الأصلى، ونجاحه فى نقل هذا الاشتغال بمهارة للفرنسية؟
نعم، قرأت لجنة التحكيم الرواية باللغة العربية، إذ بين أعضائها قراء باللغة العربية، وقارنوا الترجمة بالأصل، ورأوا كيف تعامل المترجم مع التحديات المختلفة. وجدوا اللغة الأمهرية ووجدوا بعض اللغات السودانية المحلية الخاصة جدا.
ورأوا كيف تعامل لوفان مع هذه اللغات، ومنحوه الجائزة. كزافييه لوفان ترجم كل أعمالى، وحاليًا حتى هو شبه تفرغ لترجمة أعمالى. وهو بالأساس عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بروكسل.
أى أن هذا التعدد اللغوى ظهر بطريقة واضحة فى الروايات؟
نعم، وفى «الغراب الذى أحبني» يتضح حتى تأثرى بلغات أخرى. فى نوفيلا موجودة فى خماسية «الغراب الذى أحبني» مثلًا، سوف تجدين قصائد صوفية باللغة الفارسية، وقصائد بالإنجليزية، وقصائد باللغة الألمانية، وجملًا باللغة الفرنسية، وجُملًا بفرنسية خاصة بجنوب فرنسا، ولا تُستخدَم حاليًا.
وكذلك فى رواية «سماهاني» اللغة السواحيلية موجودة، لكنها ليست السواحيلية المعاصرة، بل السواحيلية قبل مائتى سنة. أنا أعتبر نفسى عكس مقولة كاتب ياسين عن أن اللغة الفرنسية غنيمة حرب. لا، أنا غنيمة اللغات. أنا غنيمة كل هذه اللغات. اللغات اغتنمتنى، وهى تؤثر فى كتابتى، تؤثر فى سلوكى، تؤثر فى معركتى، فى حياتى اليومية، فى كل شىء.
بالمناسبة، ما هى لغة أمك؟ وما هى لغة أبيك؟
لغة أمى اسمها «بلالة”، ولغة أبى اسمها «الماسارا”، وهى قبيلة ضخمة جدًا اسمها «المساليت» وترجع جذورها لقبيلة «الماساي”. وقد عرفت جذور قبيلتى قريبًا، حين أجريت اختبار الحمض النووى السنة الماضية، وكانت النتيجة غريبة جدًا. قلت ماذا حدث؟ فأجريت الاختبار لأفراد من قبيلة أبى، وجاءت النتيجة مطابقة تمامًا لجذورنا.
وهذه القبيلة تعود جذورها إلى جنوب مصر وشمال السودان. هذه هى المنطقة التى توجد فيها قبيلتى أصلًا، وبدأت الهجرات قبل ستمائة سنة. كان هذا وقت دخول العرب والحروب. قامت القبيلة بهجرتين، هجرة اتجهت جنوبًا وهم الماساى، فى كينيا وأوغندا، وهناك جزء اتجه إلى جنوب تونس، وجنوب المغرب، الخ، إلى أن استقروا فى دارفور.
ولا يوجد ماساى حاليًا فى السودان. هاجروا، هم أخذوا اسم ماساى ونحن ماسارا. نرقص نفس الرقص، ونغنى نفس الغناء ولنا نفس العادات والتقاليد ونفس الثقافة، لكنهم فى دارفور أسلموا. أصلا من أين دخل الإسلام السودان؟
من الغرب وليس من الشمال. لَمَّا جاء عبد الله بن أبى السرح وحاول أن يدخل أرض النوبة حاربوه وهُزِم فى ثلاث معارك، فعقد معاهدة البقط بين النوبة وبين العرب المسلمين. وكان يوجد بعض الأعراب الرعاة، وهم من بعض القبائل الرعوية مثل جهينة.
وكانوا يرعون فى السودان، فحمت الاتفاقية هؤلاء، وأقرت بأن يأتوا راحلين غير مقيمين. لا يقيمون فى المدن، بل على أطراف القرى. ثم دخل الإسلام السودان لاحقًا عن طريق الغرب بعد سقوط الأندلس والهجرات من المغرب وطريق الحج، الخ. وبذلك دخل الإسلام بشكل مختلف جدًا.
وفى الندوة التى شاركتُ فيها بمهرجان الكتاب الإفريقى هنا فى مراكش، قلت إننى تعلمت أن أكون أفريقية، فالرافد الأفريقى فى هويتى الشخصية لم يكن واضحًا أو معطى تلقائيًا، بل هو شيء اخترته واشتغلت عليه، وقد أيدنى الكاتب الجيبوتى عبد الرحمن وافيرى فى رؤيتى هذه الخاصة بأن الهوية الأفريقية ليست معطى جاهزًا سلفًا.
حين تتحدث أنت الآن عن جزء من التاريخ الأفريقى أو عن العلاقات بين القبائل والأعراق الأفريقية المختلفة وكذلك اللغات المحلية العديدة، يتضح الثراء الكبير لهذه القارة، مثلما يتضح التباين الشاسع بين شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كأن هناك حاجز يفصل الشمال عن الجنوب. عن أى هوية أفريقية نتحدث فى هذه الحالة؟
وفى رأيى لا توجد هوية أفريقية، كما لا توجد هوية أوروبية أو عربية! يوجد اختيار سياسى. ما يُسمّى بالوطن العربى هو فى حقيقته الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الوطن العربى من ابتداع القوميين العرب، وهم عندما قاموا بهذا الشيء لم تكن فكرتهم عنصرية، بقدر ما كانت فكرة تطمح إلى قوة اقتصادية وقوة اجتماعية وتعاضد، مثلها فى هذا مثل الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة، الخ.
وكانت فكرة نقية لكنها سببت مشكلة كبيرة، لأن معظم هذه المجموعات لها جذور أخرى غير عربية، حيث توجد أقليات وجيوب، الأمازيغ الأشوريون، الخ. هم تجاوزوا هذا. المثقفون السودانيون أو من يسمونهم بالطليعة المثقفة هى التى حكمت بعد الإنجليز مباشرة، لم يفكروا جيدا فى مسألة الهويات. كان وعيهم ضعيفًا جدًا فى هذه المسألة. أقروا السودان دولة عربية وهذا تسبب فى حروب هوياتية من ذلك الوقت إلى اليوم.
بسبب القفز على التنوع والثراء العرقى الموجود؟
نعم. قفزوا على التنوع الموجود والديانات الموجودة. لدينا فى السودان ديانات محلية كثيرة جدًا و أسرتى عندها دينان وجدودى لأمى عندهم دين وعندهم نبي. وأمى رحمها الله، إلى أن رحلت مسلمة، لكنها ظلت تؤدى طقوسًا سنوية تخص هذا النبى، ولو قلتِ لها هذه خرافات تعتبرك كافرة. هذا النبى لم يولد من أب ولا من أم. بل تورمت ساق رجل من الرجال ووُلِد هو منها.
هذه هى الأسطورة الخاصة به؟
لو قلتِ لأمى أسطورة لاعتبرتكِ كافرة. هذه حقائق بالنسبة لها. تورمت ساق رجل فذهب لحكيم القرية، فجرح الساق وخرج منها الجد. هذا جدنا، جدنا المعجزة. ويجب أن تؤمنى بهذا. أحكى هذا لأقول أن هناك ديانات ومعتقدات كثيرة جدًا فى أفريقيا.
وأنا أحترم تراث أجدادى. فى أفريقيا توجد هويات مختلفة، ليست هويات لدول ولا حتى هويات لقبائل، بل هويات لأفراد. الأفريقى مثله مثل الأوروبي. الشخص الذى وُلِد وعاش فى أفريقيا مثل الشخص الذى وُلِد وعاش فى أوروبا أو فى أمريكا... الخ. يكتسب هويات يوميا ويفقد هويات يوميًا.
وهل نقول هوية الأفريقى أنه أسود؟ اللون ليس هوية. ويوجد بيض أفكارهم تتماشى مع أفريقيا ويوجد أفارقة أفكارهم بيضاء. اللون لا يمكن أن يوحد البشر أبدًا. لكن توحدهم علاقات، وأفكار ذات علاقة بالسياسة بالاقتصاد بالمستقبل، بوعى التضامن البشرى الإنسانى، هذه الأشياء كلها تخلق ترابطًا أكبر بين البشر. أفريقيا مكان، أوروبا مكان آخر، أمريكا مكان آخر، أستراليا مكان آخر.
وهذا هو فهمى للأمكنة. الإنسان الذى يعيش فى هذه الأمكنة يحمل هويات متعددة والهويات ليست ثابتة، وهى متغيرة دائما وديناميكية وهى فى طور التكون، إلى أن يموت الإنسان وهويته فى طور التكون. لذا فعلاقتى بالكتاب الذين من أفريقيا هى علاقة كتابة، وعلاقة أدب وعلاقات إنسانية.
والموضوع الآخر، هؤلاء الكتاب ربما لم يجدوا الفرص التى وجدها الكتاب فى أوروبا. فى إثيوبيا مثلًا يوجد كتاب عظام يكتبون باللغة المحلية، لأن هناك فى إثيوبيا يتحدث أكثر من مائة مليون اللغة الأمهرية، ويكتب الكتاب بها كلغة أساسية. ماذا فعلت؟ ذهبت إلى إثيوبيا.
وإلى جامعة هناك، وطرحت عليهم فكرة أن أترجم الأدب الإثيوبى من اللغة الأمهرية إلى اللغة الإنجليزية ثم إلى اللغة العربية. هذا الأدب غير المترجم معروف جدًا فى إثيوبيا وغير معروف خارجها. أعجبتهم الفكرة رغم شعورهم بأنها مستحيلة لأن هذا لم يحدث فى تاريخ إثيوبيا. فأعددت أنطولوجيا الأدب الإثيوبى وهى أول أنطولوجيا للقصة القصيرة فى إثيوبيا.
ونُشِرت باللغة الإنجليزية وسوف أترجمها للغة العربية. عندى أنطولوجيا الأدب فى القرن الأفريقى، الصومال، جيبوتى، السودان، جنوب السودان وإريتريا. أنهيت هذه الأنطولوجيا وفيها 77 كاتبًا وكاتبة باللغة االعربية.
وأعمل حاليًا على أنطولوجيا الأدب المكتوب فى دولة تشاد بالعربية والفرنسية، وأيضًا على عمل آخر للأدب الشفاهى فى مائة لغة غير العربية والفرنسية واللغات المعروفة. انتهيت حتى الآن من 13 لغة.
ما الجهة الداعمة لمثل هذه المشروعات؟
لا أحد يدعمنى ولم يدفع لى أحد مليمًا واحدًا. الفلوس التى أكسبها من كتبى تساعدنى فى نشر هذه الكتب. لا أحد فى الكون يساعدنى، لا أذهب طلبًا للدعم ولا أريد حتى أن يساعدنى أحد.
بدأت شهرتك فى الغرب من خلال بوابة فرنسا والجوائز الأساسية التى حصلت عليها، كانت من خلال الترجمات للغة الفرنسية، ورغم هذا تعيش فى النمسا وتعلمت اللغة الألمانية. لماذا لم تستقر فى فرنسا باعتبارها المكان الذى انطلقت منه أدبيًا؟
عندما جئت إلى النمسا، كنت لاجئا، لكن الاهتمام بالأدب فى النمسا يحتاج للأسف إلى حركة كبيرة من الكاتب نفسه: علاقات ومجهود.. الخ. المسألة غير مؤسسية، أو بمعنى آخر، توجد مؤسسات، لكننى لا أعرفها. وطلبوا منى أن أعمل. ماذا أعمل؟ لا أعتبر أن هناك عملًا سيئًا. وقد اشتغلت فى السودان فى أعمال كثيرة وبسيطة.
وفى كل شيء وأى شيء. لكن أنا فى عمر ليس لى أن أضيعه فى عمل بعيد عن الكتابة:. قلت لهم أنا كاتب. قالوا لي: هذا ليس عملًا! فبعد طلب اللجوء ظللت أعمل أربع سنوات أعمالًا متفرقة، لكن مللت من هذا وتوقفت. فأخبرونى أنهم بحسب القانون، لن يقدموا لى أى دعم كلاجئ، لا دعم أسرة، ولا دعم بيت ولا أى شىء.
وهذا ليس فى النمسا فقط، كل دول أوروبا تعمل بنفس الطريقة. قبلت هذا التحدى: ألا أحصل على نقود من الحكومة كلاجئ. فى هذا الوقت وقعت عقدًا مع دار نشر «زولما» الفرنسية، ومنحتنى الدار مبلغًا كبيرًا. فقلت سأعيش بهذه النقود حتى تنفد، وحين نفدت قررت الخروج من النمسا.
وذهبت إلى فرنسا. كان الأمر مختلفًا كثيرًا هناك. توجد مؤسسات تهتم بالكتاب والكُتَّاب سواء أكانوا فرنسيين أم جاءوا لفرنسا من بلاد أخرى بشرط أن يعتبروهم كتابًا دوليين، فتدعمهم المؤسسات الثقافية فى هذه الحالة. وهذه لم تكن مسألة سهلة.
وإذ تحتاج إلى وقت وفحص. نصحنى أصدقائى الفرنسيون بالتقدم لهذه المؤسسة، فتقدمت وبعد فترة طُلِب منى تقديم كتبى المنشورة بلغات أخرى، فأرسلت لهم كرتونة كبيرة من الكتب المنشورة بلغات أخرى، وبعد فترة اتصلوا بى وقالوا نحن اعتبرناك كاتبًا دوليًا مقيمًا فى فرنسا، وسوف ندعمك.
ومنذ ذلك الوقت تغيرت حياتى تمامًا. حصلت على ست جوائز أدبية فى فرنسا، وعلى منحة تفرغ للكتابة، ورجعت حاليًا النمسا ومنحونى هناك منحة «كاتب مدينة جراتس» لمدة سنة. النشاط الأدبى فى فرنسا يُعتبَر الأكبر فى أوروبا كلها.
ولديهم موسمان أدبيان فى العام، يطبعون فى الموسم الواحد منهما حوالى 560 رواية، روايات فقط. اللغة الفرنسية أكبر من اللغة الألمانية لجهة عدد المتكلمين بها. الثقافة فى فرنسا جزء من آلية الحياة.
ما الذى يعوق انتشار الأدب المكتوب باللغة العربية فى أوروبا من وجهة نظرك؟
توجد عوائق مختلفة، منها ما يخص القارئ. فمن يقرأون الأدب المترجم فى أوروبا تبلغ نسبتهم 20% ما عدا الأدب الأمريكى، حيث من الممكن أن يقرأوه بنسبة أعلى. اللغات الأخرى 20%. من يقرأون كتبًا مترجمة عن العربية ربما تصل نسبتهم إلى 5%. لماذا؟ لأن في إسبانيا مثلًا ، الكتب التى تُترجَم من اللغة العربية فى السنة قد لا تتعدى ثلاثة كتب؛ ثلاث روايات أو أربع روايات.
وفى فرنسا من الممكن أن تصل إلى عشرة كتب سنويًا. لكن من ناحية أخرى، توجد مشكلة تخص الكاتب العربى نفسه. هناك كتاب جيدون طبعًا، لكن يوجد كتاب لديهم خلط كبير جدًا بين لغة الرواية ولغة الشعر. يكتبون الرواية بلغة الشعر. فلا يفهم القارئ ماذا يريد أن يقول هذا الروائى.
وهذا الكاتب قد يجيد الشعر، أوكى، اكتب شعرًا. وهم من الممكن أن ينشروا شعرًا، لكن عندما يقرأ الناشر الأوروبى هذه الرواية ويجد لغتها مغرقة فى الهندسة اللغوية ومغرقة فى الأخيلة الشعرية، حتى إذا أراد الكاتب أن يقول جملة بسيطة مثل: «ذهب الرجل من هنا إلى هناك».
ويضعها بطريقة شعرية لا تعطى المعنى المباشر، وتعيق وصوله للقارئ. فلغة الرواية ليست لغة الشعر. لغة الرواية لغة محددة تمامًا، وشعرية الرواية لا تكمن فى اللغة، شعرية الرواية فى الأحداث.
وفى طريقة رسم المشاهد والعلاقة بين عناصر كل مشهد
نعم، اللغة فى الرواية هى أداة للتوصيل، شعرية الرواية تكمن فى بناء المشاهد واستخدام الأدوات الروائية بمهارة ومواقع الراوى والعلاقات بين الجمل نفسها، وطريقة وضع هذه الجمل فى النص. كثير من الكتاب لا يفهمون هذا الفاصل الدقيق جدًا بين لغة الشعر ولغة الرواية.
لغة الرواية لغة محددة تمامًا، شعريتها فى المشاهد، فى التيمات، فى أشياء أخرى. الشعر، هندسة اللغة، لأن الشعر هو عمل فى اللغة. وأنا فى رأيى أن أى قصيدة شعر يستطيع القارئ أن يفهمها من القراءة الأولى، ليست شعرًا. الشعر إحساس، تكوين باللغة يوصل إحساسًا معينًا.
والشعر صعب. هذا الشخص غير قادر على أن يصبح شاعرًا كبيرًا ولم يستطع أن يصبح روائيًا جيدًا. هذه إشكالية كبيرة جدًا. المترجم لا يعرف ماذا يترجم.
فى رواياتك ومن كلامك عن البيئة التى نشأت فيها ومنابع الإلهام عندك، سودان آخر مغاير لما نجده عند الطيب صالح، وعند روائيين آخرين. هذا التنوع فى الأعراق والثقافات واللغات والبيئات المختلفة فى السودان، هل يمكن أن نتحدث معه عن أدب سودانى؟ وما الذى يمكن أن يجمع كل هذا؟
لا يوجد أدب سودانى، كما لا يوجد أدب مصرى. كيف يكون يحيى الطاهر عبد الله أديب مصرى، وفى نفس الوقت محمد مستجاب أديب مصري. ما هى الميزات فى هذا الأدب المصرى؟ كيف يُكتَب الأدب المصري؟ ما اللغة التى يُكتَب بها الأدب المصرى؟ ما التقنية التى يُكتَب بها الأدب المصرى؟ نفس الحكاية فيما يخص الأدب السودانى ما بين الطيب صالح وأبو بكر آدم إسماعيل.
ما بين الطيب صالح ومنصور الصويم. ما العلاقة؟ وبالتالى، رأيى أنه يوجد أديب، وتوجد تقنيات للكتابة. صحيح، توجد آلاف الروايات المصرية، لكن ليس لناقد ولا لأكاديمى أن يضع قانونًا يقول هذا هو الأدب المصري. يُكتب بالأدوات الفلانية، يكتب باللغة الفلانية، وموقع الراوى فيه كذا.
وتُبنَى الأحداث فيه بالطريقة الفلانية. بناء الشخصيات يكون كذا. لم أجد هذا الكاتالوج، أو ما يُسمّى بالجدول. نفس الأمر مع الأدب الروسى، وغيره من الآداب. يوجد كاتب، ولا ينتمى الأدب إلا للكاتب. أدب نجيب محفوظ، أدب يحيى الطاهر عبد الله، أدب طه حسين، أدب الطيب صالح، أدب أى شخص آخر.
فى النهاية، ما رؤيتك لمنجز الأدباء السودانيين؟ وهل هناك كتاب معينون ترشحهم للقراءة؟
سأقول لك. أنا أولًا لست مع مصطلح الأدباء السودانيين، أفضل عليه «أدباء من السودان». أعددت أنطولوجيا للقصة القصيرة تحوى سبعة وسبعين كاتبًا وكاتبة، لو مررتِ على هذه الأسماء، وهى من الجنوب، ومن الشمال، ومن الشرق، والغرب، ستجدين أسماءً كثيرة جدًا. من بينهم مثلًا: أحمد أبو حازم، وهذا خطير فى القصة القصيرة، محفوظ بشرى.
هو شاعر وقاص. عماد البليك، هذا روائى وعنده طريقة جميلة جدًا فى الكتابة. صلاح البشير، هذا أستاذ. محسن خالد، هذا مجنون، شيطان كتابة، غير معروف وغير مترجم. عبد الباسط مريود، عبد الغنى كرم الله، هذا فنان تشكيلى وروائى. بثينة خضر مكى. سارة الجاك؛ شابة تكتب بشكل جميل. أسماء عثمان. عثمان الشيخ. ستيلا جايتانو. رانيا مأمون. صباح السنهورى؛ شابة تكتب الرواية ومترجمة الآن للغة الألمانية، وتكتب قصة قصيرة ممتازة. ريهام حبيب الله. هبة الأمين. أسماء كثيرة جدًا. وفى الجنوب روزا يوسف،وسوزان عبد الله.
اقرأ ايضاً | د. إبراهيم منصور يكتب: سمير الفيل في سرده.. هذا الطفل هو أنا
نقلا عن مجلة الادب : 2023-3-19
















