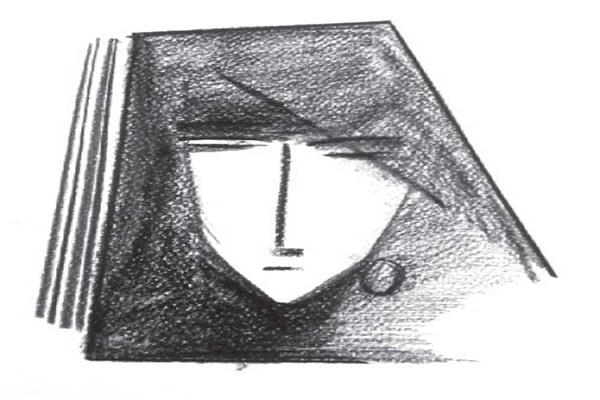حاتم عبدالله
تذكرته فور وصولي لبلدتي، وفوجئت أنني لم أره منذ ما يقرب من عقدين، كأني عائد من نومة أهل الكهف.. كيف مر كل هذا الوقت بلا التقاء به، وهو الأخ الأكبر والصديق الذي لم أكن أفارقه.. سارعت إلى ابنه الصغير لكي يدلني عليه، أخبرني أنه ما زال يعيش في شقته الصغيرة بأسيوط، مع زوجته الثانية، وأنه أنجب منها آخرين.
تذكرت أخيرا أن حزنا كبيرا سكن قلبه، إثر تعرضه لغدر من صديق ثالث، كان همزة الوصل في تعارفنا، وأنني لم ألتقه من قبلها بحوالي خمس سنوات، وخمنت أن علاقتنا كانت ضحية لهذا الحزن الذي أصابه، دون ذنب مني، لكني لم أتذكر أبدا ما الذي منعني عنه منذها، ولم فرطت في علاقتي به بهذه السهولة فاستسلمت للانفصال، ولم لم أحاول التواصل معه.
أجهدت ذهني وأنا أتخيل مدى التغيير الذي يمكن أن يكون قد أصابه بعد كل هذه السنوات، هل تهدلت قامته السامقة، أم امتدت بوادر الصلع إلى باقي رأسه ذي الشعر الأخشن، أم اشتعل هذا الشعر، الذي كان فاحما ومخبئا بسوالفه الأذنين، بالشيب.
نسيت الحصول على رقم هاتفه من ابنه، للتمهيد للحظة اللقاء، كنت على يقين أنه سيفتح ذراعيه الطويلتين على اتساعهما ليحتضنني، كما اعتدنا، في زياراتي للبلدة.
كنت أتحين تلك اللحظة وأكاد أعيش حدثها ومشاعرها قبل حصولها، مشحونة بالدموع وأزيز بكاء، مصدره كل أبعاضي، المادية والروحية، الماضي الثري والحاضر الخشن.
نصحني ابنه، الذي كان ما زال جانبي في هذا المساء، أن أنتظر لبراح الغد، صباحا أو ظهرا، لكني لم أستطع البقاء، كان الدافع مزدوجا، قوة ذاتية وأخرى فوقية جارفة، أدركها ولا أستطيع وصفها.
في الطريق إليه، سلكت السيارة اتجاها، يناقض ذلك المؤدي إلى مدينة أسيوط، كانت إرادتي هي المحرك، عبر طريق أعرفه جيدا، اصطحبت فيه كثيرين قبلها، حميمين وأقارب ومعارف، وأقارب المعارف.
كان المشوار مظللا كل المحيطين بشجن معتاد، لكني كنت أتحلل من أثقالي تباعا، تحضر الذاكرة بحكاياتها وتفصيلاتها بقوة، وتسقط قطعة قطعة عبر الطريق.
بلا أسف يسقط معها الوجع والطمع والخوف والتشتت وفق ترتيب مسبق وفي بقاع ليست عبثية، تفريغ يمهد لاستقبال وعي مختلف.
يسير الركب وأطير فوقه، يتعثرون في فصوص الذاكرة المبعثرة، لتصنع مسافة عظيمة بيننا، أراها بمفردي ولا يحسونها.
وأرى الرفاق خلفي بطيئين، مقيدين بالماضي ومتشبثين باللحظة، داخل إطار ذي أفق خانق، تجاوزته عيناي إلى ما لا رأوا ولا سمعوا ولا أدركوا.
ألقيت عليهم نظرة أخيرة، يجللها عفو عام ومحبة بحجم السماء، مسحت ببصري وجوههم، وفي لحظات أدركت اللاحقين؛ الأوائل والمتأخرين منهم، ناديت أبشرهم بالبراح، لكن غبار الأرض ونعيق الغربان حالا دوننا.
أبصرت عوالم الحقيقة خلف إطار الأفق، فتذكرت صورا أرضية هشة، ضلت طريقها في استنباط الأصل ومحاولة تقليده.
علاقات حمقاء مرهقة تنفصم عراها، وأنساب أكثر توافقا تغزلها يد حانية، فتلتئم خيوط، اشتد بها الشوق، إثر طول فراق، لتخلق نسيجا أبديا، لا يهترئ.
ما بين العالمين اختلاف عظيم، لحن حزين ينبعث من نحيب الحميمين، وموسيقى فرح وزفاف تملأ أذني.
وقبل نقطة النهاية، أدركت أني جئت وفق استدعاء الرحلة الأخيرة، ورأيت صاحبي يعلو مسكنه الصغير، وهو يفتح جناحيه، بجوار غرفة مشابهة، يظهر منها والدي، بابتسامته الخجلى، ووجهه الدموي الرطب، وسمعت أهازيج منعشة، وأصواتا رخوة، لكائنات متباينة، بألوان ذات بهجة، تملأ الفضاء، وتحتجز طنين أطفال الرحمة، في أرض الراحة الأبدية.
تقول ابنتي لما رأت طول رحلتي.. فراقك هذا تاركي لا أبا ليا*