يتخطى المؤتمر حاجز المركزية البغيضة التى دأبت على تركيز الغالب الأعم من الأنشطة الثقافية فى العاصمة دون غيرها من المحافظات.
إنشاء جائزة النخيل للإبداع الثقافى والحفاظ على مقابر ومقتنيات أعلام الأدباء والمفكرين.. أهم ما وصت به الدورة الـ 35.
ناقش المؤتمر قضية (الفعل الثقافى ومشكلة المعنى) مستقطبًا باحثين من طراز رفيع، يُعيدون تأمل المسكوت عنه فى الثقافة .
شهدت الأيام الثلاثة الأخيرة من عام 2022 بعثا جديدا لمؤتمر أدباء مصر، الذى عُقد فى محافظة الوادى الجديد، بعد توقف دام لعامين متصلين، بسبب جائحة كورونا التى اجتاحت العالم، وأوقفت الكثير من أنشطته، ما أعطى لهذه الدورة التى رأسها الكاتب الكبير محمد سلماوى أهمية خاصة، إذ شارك فيها أكثر من 350 أديبًا وباحثًا وإعلاميًّا، وحملت اسم المثقف الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد الذى أثرى حياتنا الثقافية بتأصيله لتخصص نادر، وهو علم نفس الإبداع الذى لم يسبقه إليه إلا أستاذه الدكتور مصطفى سويف، كما ناقش المؤتمر قضية (الفعل الثقافى ومشكلة المعنى) مستقطبًا باحثين من طراز رفيع، يُعيدون تأمل المسكوت عنه فى الثقافة بطرح أسئلة تتمتع بالجسارة، ولعل طرح هذه الأسئلة يمثل فى حد ذاته فعلًا ثقافيًا أصيلًا يُحسب للمؤتمر، الذى آثر أن يفتح الأفق أمام فهم العمل الثقافى وتجلياته.
ويعد المؤتمر بمثابة البيت الذى يلم شمل أدباء مصر، على حد وصف سلماوى، الذى قال إن المؤتمر يتميز بعدد من الصفات الفريدة التى لا تشاركه فيها أية فاعلية ثقافية أخرى، «فهو يتخطى حاجز المركزية البغيضة التى دأبت على تركيز الغالب الأعم من الأنشطة الثقافية فى العاصمة دون غيرها من المحافظات.
وذلك بالرغم من أن الكثير من الأشجار الوارفة التى نستظل بظلها فى بستان الثقافة المصرية كان منبتها فى تلك المحافظات المهمشة التى امتد عطاؤها على مدى السنين، من طه حسين والعقاد وحافظ إبراهيم إلى يوسف إدريس وأمل دنقل وعبد الرحمن الأبنودى، وهى مازالت تقدم لنا البراعم الأدبية الواعدة التى ستنمو عما قريب لتصبح أشجارًا باسقة وتضيف لبستاننا خضرة يانعة».

وأضاف أن قيمة المؤتمر تكمن فى أنه منذ نشأته عام 1984 لم يعرف التفرقة بين أديب سكندرى وآخر أسوانى، بين شاعر بورسعيدى أو سيناوى، فالأدباء جميعهم سواء، ولكل منهم تفرده الأدبى.
وغياب أو تغييب البعض يشكل نقصًا معيبًا فى لوحة الفسيفساء الأدبية الضخمة التى تفخر بها مصر. واستطرد: «لقد التحم المؤتمر منذ نشأته بالقضية الوطنية، بحكم الارتباط الطبيعى الوثيق بين الأديب والوطن، فكان للمؤتمر فى جميع دوراته موقف راسخ ومستقر مع قضيتنا الكبرى، قضية الصراع الوجودى مع عدونا الأول على مدى ثلاثة أرباع القرن.
والمتمثل فى دولة الاحتلال الصهيونى العنصرية التى مازالت تناصبنا وسائر الشعوب العربية العداء، رغم الاتفاقيات التى وقعتها ومازالت توقعها مع الدول العربية، والتى وإن ظلت جميعها اتفاقيات ملزمة للحكومات التى وقعتها، فهى لم ولن تؤدى إلى علاقات طبيعية مع الشعوب العربية الرافضة للاحتلال الوحشى وللظلم والعنصرية».
ومن ناحية أخرى، فإن إحدى مميزات المؤتمر -كما يرى محمد سلماوى- أنه يقوم فى تشكيله على الانتخاب، فأمانته العامة المسيرة لأموره هى أمانة منتخبة لا تعيين فيها من وزارة أو أى جهة رسمية أخرى.
وهى التى تختار الرئيس من كبار الأدباء فى كل دورة من دورات المؤتمر، ومن هنا فإن المؤتمر العام لأدباء مصر هو المعبر المباشر عن موقف جماعة الأدباء المصريين، والقرارات والتوصيات الصادرة عن جلساته هى انعكاس مباشر لمواقف أدباء مصر من مختلف القضايا السياسية والثقافية.
وقد أوصى مؤتمر أدباء مصر فى دورته الـ 35 بالآتى: أولًا: التأكيد على التوصيات السابقة للمؤتمر وأهمها رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى وكفالة حرية التعبير ورفض وصاية المؤسسات الدينية على الإبداع. ثانيًا: زيادة دعم الأنشطة الثقافية الخاصة بالمناطق الحدودية. ثالثًا: ضرورة إدراج بعض المنجز الأدبى المعاصر ضمن مقررات المراحل التعليمية المختلفة.

خاصة إبداع نجيب محفوظ بوصفه أديبًا عالميًا. رابعًا: وقوف رموز ونماذج الثقافة المصرية فى خندق واحد مع الدولة المصرية ضد كل أشكال الإرهاب الغادر الذى يستهدف الوطن والمواطنين بوصفهم القوة الفكرية الأولى للدفاع. خامسًا: نظرًا لمرور خمسين عامًا على حرب أكتوبر لا بد من إيجاد آلية لجمع وتوثيق سرديات وفنون نصر أكتوبر.
سادسًا: إنشاء جائزة النخيل للإبداع الثقافى. سابعًا: وضع آلية للحفاظ على مقتنيات ومقابر أعلام الأدباء والمفكرين باعتبارهم رموزًا ثقافية للوطن. ثامنًا: إعادة هيكلة أندية الأدب وآليات الترشيح والمشاركة فى المؤتمرات الأدبية كافة.
تاسعًا: ضرورة إرسال بعثات ميدانية لجمع التراث والمأثور الشعبى بمحافظة الوادى الجديد التى تم اختيارها عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023. وأخيرًا: ضرورة الاهتمام بحفظ ورعاية الحرفة التقليدية المميزة للوادى الجديد دعمًا للاستثمار الثقافى.
وبالعودة إلى قضية المؤتمر الرئيسية وهى (الفعل الثقافى ومشكلة المعنى)، سنجد أن الأبحاث المقدمة تناولت وفق ما قاله الدكتور سعيد الوكيل أستاذ الأدب والنقد مشكلة المعنى بعيدًا عن السياق التقليدى، بالتركيز على المشهد الثقافى.
وما يزخر به من حالات ترشح لتعدد المعنى، إلى حد يصل إلى ما يمكن تسميته (السيولة المشهدية الثقافية)، وهى تعدُّدية لا تشى بالثراء بقدر ما قد تشى بحالة من فقدان وعدم الارتكاز على أسس صلبة تحتفظ للثقافة بحيوية الجدل الخلاق؛ وهو ما استلزم إعادة النظر فى الرواسب الثقافية متعددة المنابع، كاشفة عن أثرها الفاعل فى الراهن الثقافى الذى لا ينفك عن الراهن الإنسانى المعيش فى كلِّ تجلياته.
وأضاف سعيد الوكيل رئيس اللجنة المشرفة على الأبحاث أن هذا يعنى بالضرورة أن دور المثقف نفسه قد حدثت له تغيرات جذرية يجب رصدها فى هذه اللحظة التى تمتد جذورها الملتهبة إلى جذع بدايات النهضة الثقافية العربية الحديثة، فكان من اللازم إعادة تأمُّل بعض الأوهام المتعلقة بالعلاقة الملتبسة بين المثقف والذوات الأخرى الفاعلة ثقافيًا.

ففتنة الحديث عن الذات والدَّور الفاعل فى الواقع ظلت هاجس المثقف لزمن ليس بالقصير؛ فتنة أطاحت بقيمة جوهرية فى الفعل الثقافى تتمثل فى مساءلة الذات ومحاولة الوقوف على ماهية علاقة المثقف بذاته.
وبالآخر، وبماهية الفعل الثقافى ذاته، وهى مسألة تضرب بعمق فى قضية البحث عن المعنى، فى ظل عالم يزخر باللامعنى، ويعيد تعريف الثقافة على نحو يُحطَّمُ ما بدا مستقرًا فى وعى منتجى الثقافة ومتلقيها.
لكن ما المعنى؟ إنه السؤال الذى يراه بعض الناس سطحيًا، وربما يثير لديهم الاستنكار أو الاستهجان؛ إذ من الذى لا يعرف ماذا تعنى كلمة المعنى؟ فهى من المفردات اللغوية الشائعة فى العامية والفصحى ويعرفها العالم والجاهل.
ومن ثم فإنها لا تحتاج إلى تعريف، هذا الاعتراض بلا شك فيه جزء من الحقيقة وليس الحقيقة كلها، هذا الجزء من الحقيقة هو أن كلمة المعنى بالفعل من الكلمات الشائعة فى اللغة العربية المعاصرة والقديمة لكن شيوعها ليس دليلًا على تحديد مفهومها أو ثباته، هكذا يقول الدكتورعبد الرحيم الكردى أستاذ النقد والأدب العربى الحديث بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية.
ويضيف: «ومن الأدلة على تعدد الدلالات التى يحملها مصطلح المعنى أن عالمين كبيرين هما ريتشاردز وأوجدن C. K. Ogden و I A Richards حاولا حصر المعانى التى يدل عليها هذا المصطلح، فأصدرا كتابًا قيمًا سنة ۱۹۲۳م - أى منذ مائة عام تقريبًا - بعنوان معنى المعنى The Meaning of Meaning هدفه تحديد معنى كلمة المعنى، وتوصلا فيه إلى وجود ستة عشر تعريفًا لكلمة المعنى.
وهذا العدد لم يشمل كل التعريفات، بل إن الكتاب تناول أشهر التعريفات فقط، وأن عدد التعريفات التى أشار إليها العالمان الكبيران قد يتجاوز العشرين إذا أخذنا فى الاعتبار التعريفات الفرعية.
وإذا حاولنا الآن بعد مرور مائة عام على تأليف هذا الكتاب إعادة المحاولة فإن العدد سوف يتجاوز العشرين بكثير، نظرًا لاتساع آفاق المعرفة الإنسانية والتطورات التى حدثت فى العالم».

وأشار الكردى إلى أن هذا التنوع الهائل فى المفاهيم المتعلقة بمصطلح المعنى أدى إلى استقلال كل مفهوم منها بحقل معرفى خاص ومن ثم تعرضه هو الآخر لتقسيمات جديدة، واختصاصه بدراسات ونظريات متنوعة حسب طبيعة كل منها.
حتى غدت منظومة المفاهيم الخاصة بالمعنى تشبه الشجرة، فى كونها ذات جذع واحد ولها فروع وأغصان وأوراق متعددة، لكن الملاحظ على أكثر الجهود التى بذلت فى هذا الشأن أنها كانت تتحرك فى إطار مقولة محورية رئيسة واحدة تتعامل كل الاتجاهات معها كأنها مسلمة لا تقبل المناقشة، وهى ارتباط المعنى والفكر باللغة.
وفيما يرى الدكتور سامى سليمان أحمد أستاذ النقد الأدبى الحديث بكلية الآداب جامعة القاهرة أن هذا السؤال المؤرق المتعلق بمفهوم المعنى يمثل نوعًا من القلق الوجودى المتعلق بحقيقة الثقافة ودور المثقف فى تغيير واقعه، أو تثبيته، أو تبصير المتلقين بما يجب أن يكون أو دعوة هؤلاء المتلقين إلى التجاوب مع السائد من الأفكار الموروثة حول قيم أساسية بما يتيح .
لأولئك المتلقين- الاطمئنان لكل موروث وسائد من قيم حاكمة للواقع الاجتماعى والثقافى. ولهذا فإن ما طرحته الدعوات السابقة من دعوات إلى التجديد، سواءٌ فى مجال الأدب أو النقد أو الفكر السياسى أو التعليم، كان دافعًا إلى وضع عدد من المفاهيم والقيم الأساسية موضع التساؤل أى موضع البحث عن معانى تلك القيم والمفاهيم أو دلالاتها.
ويقول إن التساؤل الدائم حول قيمة الحرية كان كامنًا بقوة وراء البحث القلق عن دلالات تلك القيم أو المفاهيم، كما كان ذلك التساؤل شاملًا بوصفه البوتقة المحورية التى دار السعى إلى جلاء دلالات تلك القيم فى إطارها.
وكانت تلك البوتقة سياقًا جامعًا تتلاقى فيه قضايا الثقافة بقضايا المجتمع، مما جعل من إجابات التيارات الثقافية المختلفة كاشفة عن رؤاها للمجتمع، أو بعبارة أدق كاشفة عن رؤاها للقضية الأساسية المطروحة على الثقافة العربية الحديثة منذ بدايات القرن التاسع عشر إلى الآن؛ وهى قضية «النهضة».
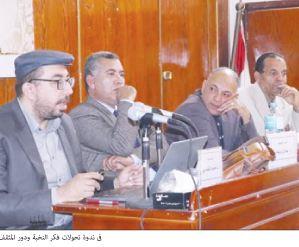
كما يرى الدكتور سليمان أن تعدد المعانى والدلالات التى تنتجها المؤسسة النقدية، أو مؤسسات القراءة المختلفة فى سياق اجتماعى ما للنصوص والخطابات والظواهر الثقافية المختلفة، إنما هو نتاج لجدل بين تلك المؤسسات المنتجة لهذه المعانى والدلالات.
ومن ناحية والنصوص والخطابات من ناحية أخرى، وبقدر ما يقوم ذلك الجدل الذى لا يكاد يتوقف على علاقات متغيرة بين العناصر التى تصنعه، فإن طبيعته تتخذ سَمْتها وسماتها من عناصر متعددة أبرزها السياق الاجتماعى والثقافى الذى تتم فيه عمليات إنتاج ذلك المعنى والدلالات والأدوات المستخدمة فى تلك العمليات، ومصالح القوى الاجتماعية التى تؤثر وتتدخل فى صياغة تلك العملية وتشكيل آلياتها.
ويضيف: «من هذا المنظور الفضفاض فى الرؤية والنظر والتقدير، يمكننا ملاحظة أن الوضعية التى تعيشها ثقافتنا المصرية أو العربية الراهنة تأتى مشروطة بعددٍ من المتغيرات الحيوية التى تدفع صناع الدلالات أو المعانى أو المؤوّلين صناع التأويلات المختلفة.
وإلى البحث عن أدوات جديدة يستخدمونها فى تأويلاتهم بقدر بحثهم عن موضوعات جديدة يتخذون منها قضايا للتأويل والحوار، ويتضح أن صناعة الدلالات للمنتجات الثقافية المختلفة من نصوص وخطابات وظواهر ثقافية كثيرة تتأثر الآن بعوامل كثيرة لعل أبرزها عاملان.
وهما ثورة يناير ۲۰۱۱ وإثارة إشكالية البحث عن المعانى والدلالات للقيم المختلفة والدور الحيوى الذى تلعبه ثورة الاتصالات المعاصرة فى إبراز أن الحيوية والوجود المستقبلى المثمر لن يكون إلا لثقافة راعية للتعدد ومحافظة عليه وداعمة لمختلف تجلياته».
وتطرق المحور الثانى لمؤتمر أدباء مصر فى دورته الـ 35 إلى «تحولات فكر النخبة»، فالمُتتبع لخارطة الثقافة العربية الحديثة فى عمومها والمصرية على وجه الخصوص، يُدرك تمام الإدراك المأزق الحضارى التاريخى الذى وجدت نخبته نفسها فيه.
وهو ما ناقشه الباحث الدكتور شعيب خلف، الذى قال: «كان على نخبتنا أن تحدد موقفًا يعبر عن تطلعها لإثبات ذاتها ووجودها، بعد أن استطاعت نخب أخرى أن تكتب تاريخ الحضارة والمعرفة الإنسانية وتضع فيه ما تشاء من ادعاءات وأكاذيب.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ظهر فريق من هؤلاء يمحو دورنا الذى كان والذى استطاع أن يحافظ على تراث الإنسانية فى حينه، ويضيف إليه، بل ويبتكر فيه، وينقله الآخرون عنه، بعد أن جعلوه عن عمدٍ حلقة مفقودة فى سلسلة تاريخ الإنسانية، ولم يكتفوا بذلك أيضًا، بل استطاعوا أن يجعلوا هذا الفقد من الحقائق التى ورثتها أجيالهم».
وأوضح أن موقف النخبة فى هذا العصر صار أكثر حيرة واضطرابًا، بل صار ينقسم على نفسه انقسامات عديدة؛ فالنخب التقليدية التى تدعو للعودة إلى الماضى والتمسك به، فى مواجهة النخب العصرية التى أفسحت الطرق للحداثة لمداهمة هذا الماضى والسيطرة عليه من خلال وضع الحاضر على مائدة الرؤية.
ومع ضرورة زحزحة هذا التراث من مكانه وصهره مع الحاضر سريع التغير. ما يطرح أسئلة ملحة كثيرة، مثل: هل المشكلة فى العودة للماضى الذى تركناه فى مكانه ولم نستجب لإلحاحه الدائم وهو فوق أكتافنا ولا ندرى وجوده؟ أم أن المشكلة فى ترك هذا الماضى والانسياق خلف حضارة حديثة لا تعترف بحاضرنا.
ولا بماضينا الذى قامت عليه أصلًا؟ أم المشكلة أننا استحلينا الفرجة، ووقفنا مشدوهين نرى العالم من حولنا يسرع الخطا ونحن فى مكاننا لا نريد أن نحرك أقدامنا من مكانها. أسئلة جعلت الأطراف كلها على طرفى نقيض كما يذهب جلال أمين؛ فلم يكن التراثيون بالطبع وحدهم فى الميدان قط.
وبل كان هناك دائمًا رد فعل يكاد أن يكون النقيض التام للعودة إلى السلف، كان هناك دائمًا من يقول إن تعثر مشروع النهضة العربية أو الإسلامية يعود إلى التخلف عن اللحاق بالغرب، وأن الحل ليس فى رفض أسس الحضارة الأوربية بل فى المزيد من الأخذ عنها.
وأكد شعيب خلف على أن صعوبة المأزق فرضت على النخبة الانقسام تجاهه: إما بالانغماس أو الانكماش، إما بالرفض التام والعودة إلى الماضي، والماضى وحده حيث النموذج والمثل الذى يمكن اتباعه والتشرنق داخله، فقد قاد بشكله وجوهره السفينة حتى وصلت لبر الأمان، فكان هو النموذج المحتذى الذى بنى العصور الوسطى.
والمعبر الذى عبرت عليه الحضارة القديمة إلى أوروبا الحديثة أو اتباع الفكر الجديد لمسايرة العصر والانقطاع التام عما مضى؛ لأنه هو المسئول عما نحن فيه من تأخر، وتراجع وتخلف عن الركب.
وعليه يجب تجربة البديل بما يحمل من إغراء للناظرين إليه من خارجه، والمتعاطفين معه من غير أهله. أما الفريق الثالث الذى رأى أن التوفيق بين الجانبين هو الأمثل فى مثل هذه الظروف فلا العودة وحدها هى الحل ولا الانقطاع التام هو المراد ولكن يجب الأخذ من التراث ما يناسب العصر والأخذ من العصر بما لا يتنافى مع قيم التراث ومبادئه.
أما المحور الثالث فتناول «الثقافة الاستهلاكية» التى تحولت إلى حالة من عدم الإشباع وعدم الرضا عن أى شىء؛ فالمجتمع اليوم الذى يحاول الاستمتاع بما هو ثقافى بلا حدود أو محددات قيمية.
إنما يخلق بذلك المُثل الاستهلاكية، مما وضع العلاقة مع المعرفة والثقافة التى كان التصور القديم لها أنها تنقل معرفة الأفراد والمجتمعات بالعالم، فى موضع تساؤل.
وترى الناقدة الدكتورة هويدا صالح أن الثقافة الاستهلاكية أزاحت القيم التى كرَّستها الحداثة والتى كانت ملزمة لكل فرد لا يرغب فى أن يجد نفسه على هامش الضوابط الاجتماعية، وأحلت محلها قيمًا ثقافية جديدة تدعو إلى الذاتية والفردانية والبحث عن متعة الاستهلاك التى لا حدود لها.
ولكن الأمر لم بعد مقتصرًا على استهلاك الطعام والشراب وطرائق العيش بل امتد إلى استهلاك الثقافة، بل نوعية معينة من الثقافة حدث فيها هى الأخرى تمثلات لقيم الاستهلاك، وحرصت على جماليات جديدة تفارق إلى حد يعيد جماليات الثقافة الحداثية.
والتى صارت توصف بأنها ثقافة تقليدية من وجهة نظر أصحاب الثقافة الاستهلاكية التى تدعو إلى ضرورة التخلى عن قيم الثقافة التقليدية لصالح تحرر البشرية نحو مزيد من الإشباع الذى تخلص من الإكراه أيا كان شكله.
وأشارت إلى أن «الهدف الأعظم فى الثقافة الاستهلاكية صار: التسويق لقيم الاستهلاك، ليس الاستهلاك المادى فقط، بل الاستهلاك النفسى لقيم السوق، والبحث عن مزيد من الرفاهية والبذخ وتسليع كل شيء، بداية من المنزل والسيارة وجهاز الكمبيوتر والهاتف المحمول.
وانتهاء بالثقافة التى تدعو إلى التحرر الغريزى والاجتماعي، والخضوع فى نفس الوقت لقيم تحول الأفراد إلى فقراء نفسيًا، تائهين غير قادرين على التفرقة بين الهوية الاجتماعية التى تنبنى على قيم حضارية ممتدة الجذور فى تربة مادية ونفسية إلى هوية مسألة تجوب الفضاءات الافتراضية بحثا عن وجود بديل ليس له مرجعية فى الواقع.
ولا سيما أن قيم الثقافة الاستهلاكية التى تعتمد على رفض الذات لنفسها فى اغتراب وهمى تفرضه ثقافة الإسالة الجديدة لكل ما هو قار مفاهيميًا ونفسيًا واجتماعيًا، وبالطبع جماليًا».
وفى هذا الشأن، يقول الدكتور سعيد المصرى أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة إن المجتمع شهد على مدى العقود الثلاثة الماضية تغيرات جذرية فى بنيته الاجتماعية والاقتصادية. ومنذ الثمانينيات من القرن العشرين وهناك كتابات كثيرة لا تكفُّ عن رصد هذه التغيرات فى نبرة لا تخلو من النقد.
وربما التحسر على ما مضى، ارتبط ذلك دائمًا بالحديث عن السلوك الاستهلاكى الجديد للمصريين باعتباره دليل إدانة لكثير من هذه التغيرات، وباعتباره تجسيدًا حقيقيًا لوجود أزمة فى المجتمع المصرى.
ويتابع: «لا شك أن دراسات علم الاجتماع للسلوك الاستهلاكى حديثة نسبيًا ليس فى مصر فحسب، وإنما فى العالم أيضًا؛ فقد كان الاستهلاك من قبل موضوعًا رئيسيًا للدراسات الاقتصادية باعتباره أحد أركان مثلث البحث الاقتصادى الذى يشمل عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
وفى الوقت الذى كان يسود فيه الاعتقاد بين أوساط الاقتصاديين أن تزايد الاستهلاك يعد مؤشرًا على انتعاش الاقتصاد كانت النظرة إلى الاستهلاك من جانب علماء الاجتماع أكثر تشاؤمًا».
ولا تخلو دراسة عن التحولات أو المشكلات الاجتماعية فى مصر من إدانة واضحة لصور وأنماط ودلالات السلوك الاستهلاكى الذى شاع بين المصريين. ويرى سعيد المصرى أنه ربما يكون هذا النقد صحيحًا فى بعض جوانبه ذلك أن كثيرًا من توجهات الناس وهوياتهم وقيمهم وأساليب حياتهم تنعكس فى المعانى المصاحبة للسلوك الاستهلاكى.
وفرغم أن السلوك الاستهلاكى الحديث أصبح أكثر قدرة على طمس الحدود الطبقية، إلا أنه يُعيد من جديد رسم صور جديدة للتباين بين الناس، ومن ثم يظل الاستهلاك بمعانيه والدلالات المصاحبة له مرآة لمجتمع يجابه العولمة بأمواجها العاتية.
وذلك فإن المغالاة فى إدانة السلوك الاستهلاكى واعتباره دليلًا على مواضع الخلل الذى أصاب المصريين قد لا يمكننا من الفهم المنصف للعملية الاستهلاكية التى يمارسها المصريون منذ السبعينيات من القرن الماضى وحتى يومنا هذا.
اقرأ ايضًا | «الوادي الجديد» تستضيف الدورة 35 لمؤتمر أدباء مصر بعد توقف استمر لعامين














